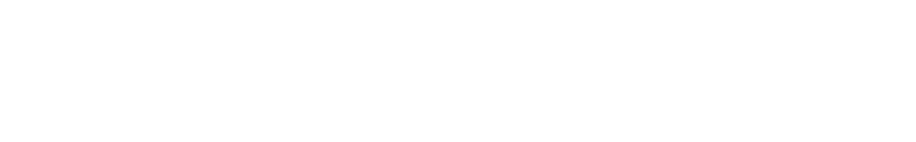الوطنية بريس حميد عسلاوي
مما لا شك فيه أنَّ عالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين جميع فئات البشر-على اختلاف أديانهم وأجناسهم- أكثر من أي وقت مضى، نظراً لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بسبب ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية صغيرة ممّا يحتِّم على الجميع التفاعل والتعاون من أجل حياة سعيدة آمنة، ومستقبل واعد أفضل وأجمل.
وهذا كلّه لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع إلاَّ بترسيخ مفاهيم التسامح الدينيِّ، وتطبيق مبادئ التعايش بين فئات البشر على تنوعهم واختلافهم، والتعاون بينهم جميعا لخدمة الإنسانيَّة والنهوض بها إلى مراقي التقدم، والعمل على إرساء الأمن والأمان على وجه هذه المعمورة، وإفشاء السَّلام العادل والشامل في مختلف الميادين والمجالات. فالبشرية اليوم-وقد أنهكتها الحروب والصراعات-بأمسِّ الحاجة إلى تسامح فعّال، وتعايش واقعيٍّ لكي تتخلّص من مشاكلها وأزماتها التي تعصف بها بسبب طغيان الغلو والظلم والكراهية بين فئات البشر.
وفي الحقيقة فإنَّ هذا التسامح المنشود، والتعايش المأمول لا يناقض تعاليم الإسلام الحنيف كما يظنُّ بعض من لم يفهم الإسلام على حقيقته السمحة المعتدلة، بل هو ممّا يدعو إليه الإسلام الحنيف ،ويؤكّد عليه في نصوص متكاثرة، ولذا فإنَّ التسامح والتعايش بين فئات البشر وفق المنظور الإسلامي: قاعدة راسخة، وفضيلة أخلاقية، وضرورة بشرية، وسبيل لضبط الاختلافات وإدارتها إدارة صحيحة هادفة، والإسلام-كما هو مُقرَّر- دين عالميٌّ يتجه برسالته وتعاليمه ومبادئه إلى البشرية كلها، تلك الرسالة الجليلة والتعاليم السمحة التي تأمر بالعدل والسماحة، وتنهى عن الظلم والعنف وتُرسي دعائم السلام في الأرض، وتدعو إلى التعايش الإيجابي بين البشر جميعاً في جوٍّ من الإخاء الإنسانيّ والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم وأوطانهم.
كما أن الإسلام الحنيف يعترف بوجود الآخر المخالف فرداً كان أو جماعة، ويعترف بخصوصيّة ما لهذا الآخر من وجهة نظر ذاتية في الاعتقاد والتصور والممارسة ممّا تخالف ما يدعو إليه الإسلام الحنيف شكلاً ومضموناً، ويكفينا-في هذا المقام- أن نعلم بأنَّ القرآن الكريم قد سمّى الاعتقادات المخالفة والمناقضة له ديناً على الرغم من وضوح بطلانها، وصراحة مناقضتها لتعاليمه جملة وتفصيلا، وعلى الرغم من ذلك سمّاها(دينا) لا لشيء إلاّ لأنَّ معتنقيها يعتبرونها دينا يدينون بها ،ويؤمنون بها.
العلاقات الإنسانية في الإسلام، تنطلق من رؤية فلسفية تقوم على أساس احترام التعَدُدية الدينية والفكرية، والاعتراف الإيجابي بالآخر، وذلك في اطار السعي لبناء حضارة اجتماعية، تعمل لخير البشرية.
وهذه العلاقة بين البشر على اختلاف أديانهم، تقوم على مجموعة من الأسس، هي:
(1) سنة الاختلاف:
التنوع والتعدد والاختلاف سنة من سنن الله ﷻ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. وكما يقول المفسرون: “للاختلاف خلقهم”.
(2) إقرار الاختلاف في الدين:
مادام الاختلاف سنة من سنن هذا الكون، فمن المستحيل أن يتفق البشر جميعاً في الأفكار والتصورات، فضلاً عن الدين، ومن المعلوم أنّ الإسلام يقوم على الاعتراف الإيجابي بالآخر، وإقراره على معتقده ودينه، قال تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾.
(3) الهداية من عند الله والحساب لله:
يعتقد المسلم أنه لا يملك الهداية لكائن من كان، فهي بيد الله وحده، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فهو مأمور فقط بتبليغ دعوة الله، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ﴾ ، وبناء على ذلك فليس لمسلم أن يحاسب أحداً لم يقبل دعوة الإسلام، فالحساب لصاحب المشيئة المطلقة يوم القيامة، قال ﷻ: ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾
لكن لماذا فشل كثير من المسلمين في فهم هذه الأسس ؟، فظنوا أنفسهم أوصياءً على المسلمين وغير المسلمين، فتم إلقاء الأحكام على الناس جزافاً، وتقسيمهم إلى مؤمن وكافر، ومنافق ومرتد، وليتهم اكتفوا بذلك، بل أجازوا لأنفسهم استباحة الدماء، فكانت بلاءً عظيماً وشراً خطيراً على الأمة الإسلامية.
هل هو الفقر؟، أم عدم الاستقرار السياسي ؟، الجواب: لا. فربما يستنتج المراقب لواقع أي دولة أو مدينة، تشهد اضطرابات سياسية، وظروفاً اقتصاديةً قاسية، تحول الأحداث إلى اقتتال داخلي، أو على الأقل وقوع عمليات نهب وسلب، لكن ذلك ليس بالضرورة هو النهاية المحتومة لهذا الواقع المتردي، فعلى سبيل المثال، كلما زادت صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية في مدينة القدس، ازدادت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين متانة وقوة وتوحدا في مواجهة المصير المشترك.
لكن كيف استطاع المسلمون والمسيحيون التعايش في القدس المحتلة، في واقع سياسي واقتصادي متأرجح ؟، فعلى مدار سنوات الاحتلال البريطاني ومن بعده الإسرائيلي لم تعرف فلسطين استقراراً سياسياً، نتيجة الممارسات العدوانية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة نهب الأراضي العربية، إضافة للاغتيال والاعتقال المتكرر للعرب، وغيرها، أما عن سياسات الاحتلال الاقتصادية، فمنها: حرمان العرب من الحصول على الوظائف، والتضييق عليهم في أعمالهم وتجاراتهم الخاصة، وفرض الضرائب الباهظة عليهم. ولذا أعتقد أن التعايش الإسلامي المسيحي في القدس، خيارٌ استراتيجي، عند القاعدة الشعبية، والنخب الفكرية، لا يمكن التفريط به، أو العدول عنه، ذلك أنه أرقى ما أنتجه التراث الحضاري العربي، المستمد من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والكتاب المقدس.
وهو في رأي المحللين قرار مصيري، على الرغم من مجمل التحديات والمخاطر التي تعيشها القدس؛ لأن البديل عنه هو التسليم بإرادة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعني الاختلاف والنزاع، وبالتالي ضعف الشوكة، وهزيمة المشروع العربي في القدس، وانتصار المشروع الصهيوني.
إذن الفشل الذي تشهده بعض البلدان العربية، في تجسيد التآخي والتعايش الإنساني، بين أطياف المجتمع، بين المسلمين وغيرهم من الأديان، بل وبين المسلمين أنفسهم في كثير من الأحيان، ليس مرده الضغوط السياسية، بقدر ما هو الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية، على حساب بقية مكونات المجتمع، وليس الفقر أو الوضع الاقتصادي المتردي، بل هو في حقيقته، جشع يدفع صاحبه للتنكر للحق؛ بغية الحفاظ على مكتسبات ومصالح تجارية، وهو أيضا فهم مشوه من بعض الجماعات الإسلامية، للإسلام وطبيعة علاقته بالآخرين.
أما التسامح فهو ثمرة للتعايش ونتيجة عنه، فلا يمكن أن يكون التسامح إلا بعد عيش مشترك لجماعة من الناس، تحمل أفكاراً وتصورات متباينة، وتمارس عادات متنوعة، وتنتمي لديانات مختلفة. وهو قيمة راقية لا تصدر إلا عن نفوس كريمة، فكم من المجتمعات بحاجة ماسة لها للتخلص من كثير من المشاكل التي تكاد تعصف بها، بينما هي في القدس حاضرة ومتجذرة بين المسلمين والمسيحيين.
سيكون للتسامح الديني آثاراً على الفرد والمجتمع، أما ما هو أبعد من ذلك، فهو البناء الحضاري، الذي يعني انطلاق نمط من أنماط السلوك الإنساني، يعترف بالآخر، فيؤثر فيه، ويتأثر به، وهو ما يعني حضارة قوية وممتدة، لن تعصف بها التقلبات الاقتصادية والسياسية.
إذن هي معادلة راقية، فالتعايش السلمي، يدعو الناس إلى التسامح والتآخي، فإذا حققوا ذلك، استطاعت مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكذلك دول العالم أجمع، رسم ملامح الحضارة الإنسانية، المبنية على الحقوق والواجبات، وهذا ما أراده القرآن الكريم، عندما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾